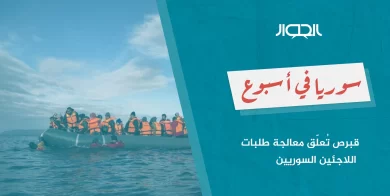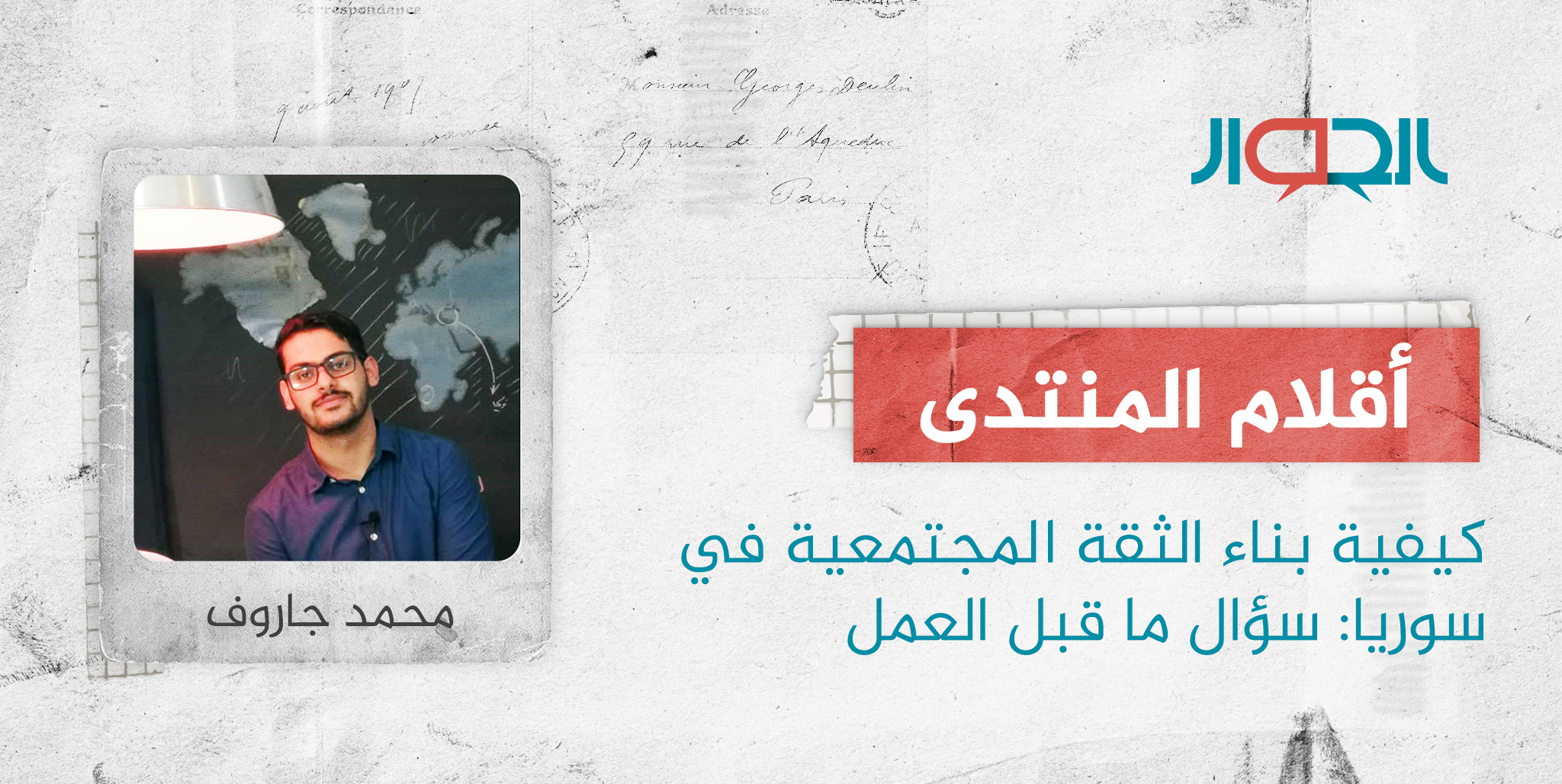
كيفية بناء الثقة المجتمعية في سوريا: سؤال ما قبل العمل
عادةً عندما يفكر الإنسان في الذهاب إلى الطبيب لا يخطر في باله أن هذا الطبيب قد يتقصّد إيذاءه، بل على العكس يكون لديه توجه عام للثّقة بأنّ الأطباء -وليس الطبيب الذي سيذهب إليه فقط- سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل شفائه، هذا الانطباع الإيجابي تجاه ما يقدمه الآخرون عادةً يطلق عليه في الأدبيات العلمية مصطلح “الثّقة المجتمعية”. هذه الثّقة التي تدخل في إطار التصور العام أكثر منه في كونها حالة خاصة بفرد أو مؤسسة معينة، كما تتضمن صوراً متعددة؛ الثقة بالأفراد، الثقة بالمؤسسات سواء الرسمية أو غير الرسمية والثقة بالعالم الخارجي.
إذا استبعدنا الثقة بالعالم “الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية”، فإنه ثمة تساؤلات كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة بين الباحثين والكتاب عن الآليات اللازمة لإعادة بناء الثقة المجتمعية بين السوريين أفراداً ومؤسسات، خصوصاً أن هذه الثقة تعرضت للكثير من الشروخ نتيجة الحرب التي شنها نظام الأسد على السوريين على مدى عقد من الزمن.
ثمة عوامل متعددة تؤثر في بناء الثقة المجتمعية، منها ما هو شخصي كالثقافة والتربية الأسرية و الديانة والعرق، ومنها ما هو موضوعي كالعوامل الاقتصادية والمؤسسية والجغرافية والتاريخية التي يكون تأثيرها في معادلة الثقة أكبر من العوامل الأولى.
في المجتمعات التي تكون خاضعة للاستبداد، تتناقص الثقة المجتمعيّة أكثر فأكثر باستشراء الفساد في مناصب الدولة، يزداد الأمر سواء كما في الحالة السورية التي اجتمع فيها الاستبداد مع الحرب الدموية التي شنها نظام الأسد. حيث يكون دور مؤسسات الدولة سلبياً؛ فبدلاً من تعزيزها للثقة، يكون دورها مدمراً، “الجيش” و”الأمن” و”القضاء” و”مجلس الشعب” كلها مؤسسات لا يعرف عنها السوريون إلا أنها مؤسسات خادمة لسلطة آل الأسد وبعيدة عن الشعب؛ كل الشعب.
في بعض الدول كسنغافورة التي نالت استقلالها بدولةٍ تعدّ الرشوة فيها سمةً من سمات الحكومة؛ شنّ البرلمان حملةً على الفساد بكافة أنواعهِ وأشكاله ما انعكس إيجابياً على الحياة المجتمعيّة للشعب السنغافوريّ وثقته بالمؤسسات الحكوميّة، وقد تشكّل سنغافورة نموذجاً حريٌّ بالسوريين اتباعه بتحويل دولة الفساد والمحسوبيات إلى دولةِ النزاهة والشفافية والمساواة، من خلال مكافحةِ الفسادِ أياً كان حجمه وموقعه من المؤسسات الحكومية والخاصة، مما يعزز ثقة الشعب بمؤسسات الدولة ومحاولة الإبقاء عليها، وإن كان هذا الأمر متعذر تطبيقه على كامل البقعة السورية، فيمكن أن تشكل المناطق المحررة بـ “مؤسساتها” القائمة كالمجالس المحليّة والفصائل العسكرية والمنظمات نموذجاً ملهماً في القضاء على الفساد والمحسوبية، ابتداءًا من معاملات الأحوال الشخصية، مروراً بصفقات استثمار الشركات والمنظمات، وانتهاءً بعزل الفاسدين ومحاسبتهم.
إلى جانب العامل المؤسساتي الذي يضعف بوضعه الحالي الثقة المجتمعية، يؤثر العامل الاقتصادي كذلك سلباً؛ حيث أن هذه الثقة تتناسب طرداً مع تحسن الوضع الاقتصادي، وبما أن هذا الأخير في أدنى مستوياته في ظل وجود 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر بحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة، فلنا أن نتصور إلى أي حد يساهم هذا العامل سلباً في الثقة المجتمعية.
قد يبدو الحل واضحاً في تفعيل الأثر الإيجابي للعامل الاقتصادي على الثقة من خلال زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد بمختلف مجالاته وزيادة معدلات النمو، ولكن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سوريا، تصبح هذه الحلول والتوصيات أقرب للأماني منه إلى قابلية التطبيق، فطالما أن حرب الأسد ضد الشعب ما تزال قائمة، فلا يمكن الحديث عن أية تنمية؛ وبطبيعة الحال عن مساهمة العامل الاقتصادي في زيادة الثقة.
ليس العاملُ الاقتصاديّ وحده العامل السلبيّ في هذه المرحلة؛ بل إن العامل التاريخيّ الحديث إن صح التعبير أيضاً يلعبُ دوراً سلبياً في بناء الثقة المجتمعيّة عند السوريين، فتأثير عشر سنوات من الصراعات والشروخ الاجتماعية كان له تأثير سلبي كبير، لنجد “انقسامات ظاهرية” عرقية بين عرب وأكراد وتركمان وآشور، وأخرى دينية بين مسلمين ومسيحيين، وثالثة مناطقية، ورابعة سياسية بين معارضين ومؤيدين. كل ذلك يجعل السنوات العشر الأخيرة بانقساماتها وشروخها طاغية على سنوات طويلة من العيش المشترك والتآلف على الأقل خلال المستقبل القريب. ولعل ذلك ما حدث على سبيل المثال مع الألمان خلال الحربين العالميتين، إذ تراجعت الثقة بين المكونات الألمانية نتيجة الحرب، مما تطلب سنوات لاحقة من العمل لتجاوز هذه الآثار.
لعل بعد هذا الاستعراض يتساءل الكثيرون، هل يعقل أنه لا يوجد عوامل إيجابية يمكن الاتكاء عليها لبناء الثقة المجتمعية في ظل التأثير السلبي لعوامل موضوعية مهمة كالمؤسسات والاقتصاد. نقول: نعم، يمكن الاستعانة بالعوامل الذاتية حالياً ريثما تتاح الفرصة للعمل على العوامل الأخرى، ويأتي في مقدمة العوامل الذاتية التربية الأسرية والمدرسية؛ حيث يمكن للأسر السورية في مختلف المناطق غرس ثقافة “الثقة” والابتعاد عن أحاديث التخوين والصورة السلبية النمطية للأخر في الوطن. كما يمكن للقيادات المجتمعية الدينية والعشائرية والوجاهية التي ما تزال محتفظة بتأثيرها داخل المجتمع، أن تقدم مبادرات ومشاريع شراكة ضمن نطاقها المتاح،
على سبيل المثال، يمكن لهذه القيادات أن تقوم بمبادرات ضمن المناطق المحررة، بما يساعد على تعزيز الثقة ضمن الشرائح المجتمعية المتنوعة “عرب وكورد وتركمان، مقيمين ونازحين، أهل منطقة أ ومنطقة ب، ….إلخ”. فوجود مرجعيات ذات حضورٍ مجتمعيٍّ قويّ عند كل الطوائف على حدّ سواءٍ ربما يسهّل على العقلاء المهمة ، إذ لا تزال المقامات الدينيّة كالشيخ والخوريّ، والمجتمعيّة كوجوه العشائر والمناطق تتمتعُ باحترامٍ يمكن الاعتمادُ عليه بتعزيز الثقة بين أفراد المكون ذاته، وتخفيف الاحتقان تجاه المكونات الأخرى. ستساعد مثل هذه الخطوات على بناء الثقة هرمياً “من الأسفل إلى الأعلى”، وبما يمثل حلاً مؤقتاً ريثما يمكن تفعيل العوامل الموضوعية إيجابياً.